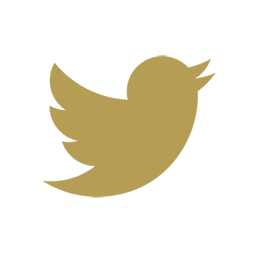القصص الّتي نقصُّها مقابل قَصّ القصص
عقدٌ من الزّمن على ربيعنا
رشا سلطي
تجمع هذه المقالة بين نسخ مختلفة لعدة مقالات نُشرت سابقاً عبر وسائط مختلفة، وهي أيضاً نُسخة من العرض التقديمي الذي قُدِّم في سياق مؤتمر "عن لحظة الفن" تشرین الثاني/ نوفمبر 2021
I
بعد أن أرغمت الانتفاضةُ الشعبيّة السلميّة زين العابدين بن علي على الفرار من تونس جوّاً تحت جنح الظلام ليلةَ 14 يناير 2011 نحو "ملاذٍ آمنٍ" في المملكة العربيّة السعوديّة، وتعالت –بعد أقلّ من أسبوعين- نداءاتٌ للتظاهر في ساحة التحرير حشدَت عدّة آلافٍ من المصريّين في 25 يناير، بدا أنّ خطأ مناصري نظريّة "الاستثنائيّة العربيّة" قد أُثبِتَ أخيراً. و"الاستثنائيّة العربيّة" نظريّةٌ واسعة الانتشار تقول بأنّ العرب يتّسمون بمناعةٍ استثنائيّةٍ على أنظمة الحكم الديمقراطيّة، ظهرت عقبَ تنامي الموجة الثالثة من "الدمقرطة" في الدول التي شكّلت الكتلة السوفييتيّة في تسعينيّات القرن العشرين، وراجت بين باحثي علومٍ اجتماعيّةٍ في مؤسّساتٍ أكاديميّةٍ غربيّةٍ حسنة السمعة، ومجامع تفكير وفيرة التمويل، تستقصي اللغزَ المحيّر الذي يسأل: متى (أو هل سيحدث أن) تنجذب المجتمعاتُ العربيّة إلى محاسن الديمقراطيّة. أحد كبار أنصار هذه النظريّة هو إيلي كيدوري، المؤرّخ البريطانيّ المتخصّص في تاريخ الشرق الأوسط، الذي جادل في كتابه الديمقراطيّة والثقافة السياسيّة العربيّة Democracy and Arab Political Culture قائلاً: إنّه لا جدوى من الترقّب؛ لأنّه «لا شيء في التقاليد السياسيّة للعالم العربي –وهي التقاليد السياسيّة للإسلام- يمكن أن يَألف، أو حتّى يفهم، الأفكارَ التنظيميّة للحكم الدستوريّ والتمثيليّ»، ويضيف: أنّ الناس «اعتادوا الأوتوقراطيّة والانقياد». درّس كيدوري في كلية لندن للاقتصاد من 1953 حتى 1990، وكانت لكتاباته سطوة كبيرة، وفي حين أنّ صياغته ومناقشاته –مثل مصطلح "الاستثنائية"- ربما بدت مفرطةً بعض الشيء في شدّتها وقسوتها، لزملائه من العلماء، أو الخبراء الباحثين في الموضوع، فالنسخة الأكثر انتشاراً، وأقلّ حدةً، تشير إلى "عجزٍ ديمقراطيٍّ" في المجتمعات العربيّة، يرتبط بأقدميّةِ الأوتوقراطيّات في المنطقة. تبلغ نظريّة الاستثنائيّة العربيّة من الرواج والنفوذ درجةَ أنّها حجبت الرؤية بالكامل عن "الخارج عن المألوف" والمنظورات المحتملةِ الأُخرى، لا سيّما ما يركّز اهتمامَه منها على التاريخ الطويل الغنيّ للاحتجاج الاجتماعيّ في كامل المنطقة.
إن تأمّلنا الاحتفاءَ بالذكرى السنويّة الخمسين للاحتجاجات الطلابيّة في مايو 1968، لوجدنا أنّ خمسة عقودٍ لم تبدُ كافيةً لتصحّحَ النظرة المركزيّة الأوروبيّة الكليلة إلى تلك اللّحظة التاريخيّة، وتأخذَ بعين الاعتبار الاحتجاجات الطلابيّةَ التي حدثت في بوينس آيرس، ولاهور، وبيروت، والقاهرة. إنّ من شأن المرور السريع على بعض الإضرابات الكبيرة، والحركات المدنيّة، والاحتشادات الجماهيريّة التي رسمت ملامح التاريخ المعاصر للمنطقة الناطقة بالعربيّة، أنْ يكشف عن صورةٍ مختلفةٍ اختلافاً جذريّاً للمجتمعات. بمجرّد الرجوع إلى أواخر سبعينيّات القرن العشرين لا أكثر؛ أي: اللّحظةِ التي شهدت بدايةَ تطبيقِ إصلاحاتٍ هيكليّةٍ مقابلَ قروضٍ ودعمٍ من البنك الدوليّ وصندوق النقد الدوليّ، نجد –في حالة مصر على سبيل المثال- أنّ انتفاضة الخبز (أو رفض رفعِ الدعم الحكوميّ عن السلع الأساسيّة، والسحبِ العنيف لشبكات الأمان الاجتماعيّ، وخصخصةِ قطاعات اقتصاديّة حيويّة مهمّة) قد حدثت عام 1977. في عام 1976، سعى أنور السادات إلى الحصول على قروضٍ من البنك الدوليّ لتخفيف حجم ديون الدولة. وبعد إدانة البنك للسياسة التي تنتهجها الحكومة المصريّة في دعم الرعاية الاجتماعيّة والمواد الغذائيّة الأساسيّة، أعلن السادات في يناير 1977 رفعَ الدعم عن الدقيق، والأرزّ، وزيت الطهو، وإلغاءَ العلاواتِ وزيادةِ المعاشات. عُرفت هذه الاحتجاجات العفويّة باسم "انتفاضة الخبز لعام 1977"، وحشدت مئات الآلاف من العمّال، والطلّاب، والناشطين في كبرى مدن البلاد. قوبلت الاحتجاجات بالقمع الوحشيّ، فلقي 79 شخصاً مصرعهم، وأصيب 800 شخص، لتنتهي بتدخّل الجيش، لكنْ جرى التراجع عن رفع الدعم. في المغرب، حدثت أعمال شغبٍ مشابهة عامَي: 1981 و1984، وفي السودان عام 1985، وفي تونس عامَي: 1984 و1986، وفي الأردن عام 1989. قُمعت جميع هذه الاحتجاجات، وفُرِّقَت باستخدام العنف المفرط، لكنّ الكثير منها حفّز على الإصلاحات وتخفيف التعديلات الهيكليّة الجائرة.
في الجزائر، حشدت أحداثُ أكتوبر عام 1988 عمّالاً وشبّاناً عاطلين عن العمل، وناشطين في مجال العدالة الاجتماعيّة والديمقراطيّة. بدأت الاحتجاجات في 5 أكتوبر 1988، وكان سببها إلى حدٍّ بعيدٍ يرجع إلى الهبوط الحادّ في أسعار النفط خلال السنوات السابقة، الأمر الذي أثّر في إيراد الحكومة الجزائريّة، إضافةً إلى أسبابٍ أُخرى تتعلّق ببطء الإصلاح الاقتصاديّ والسياسيّ. قوبلت الاحتجاجات بالقمع العنيف، غير أنّها قدحت زنادَ صراعاتٍ داخليّةٍ على السُّلطة، وانتقاداتٍ عامّةٍ، ما أدّى في النهاية إلى سقوط نظام الحزب الواحد الجزائريّ بعد أن أبقى جبهة التحرير الوطنيّ الخاضعة لسيطرة الجيش في السُّلطة منذ عام 1962، وتحرّكت بذلك عجلة الإصلاحات الديمقراطيّة. صدر دستورٌ جديدٌ عام 1989؛ إذْ قبل الشاذلي بن جديد بإقرار ديمقراطيّةٍ قوامها التعدديّة الحزبيّة، وبعد ذلك بوقتٍ قصيرٍ، تعرّض للاغتيال خلال إلقائه خطاباً على الهواء مباشرة.
لقد شهدت السنوات التي سبقت الربيع العربيّ تصاعداً في تواتر الاحتجاجات والإضرابات؛ ففي حالة تونس على سبيل المثال: تستحيل كتابة قصّة انهيار نظام بن علي بدون أن تؤخذ بعين الاعتبار نضالات عمّال شركة فوسفات قفصة، أكبر جهةٍ مشغِّلةٍ في ولاية قفصة بتونس. عقب خطّة التعديلات الهيكليّة التي نُفِّذت في 1986، وسياسات إعادة تنظيم أُخرى، كان عدد الموظّفين بحلول عام 2006 قد انخفض بنسبة 75%. لقد نشط اتّحاد أصحاب الشهادات المعطّلين عن العمل، الذي شُكِّل عام 2007، في بلدات منطقة المناجم كلّها، برفقة لجانٍ جهويّة ومحليّة. وعلى أثر حادثٍ ضمن موقع العمل في 2008، اندلعت احتجاجاتٌ استمرّت ستّة أشهر، حشدت عمّالاً وشبّاناً عاطلين عن العمل، وعمّالاً مؤقتين، وطلّاباً. كانت هذه أكبر حركةٍ احتجاجيّةٍ منذ انتفاضة الخبز التي هزّت البلاد عام 1984، وتنوّعت أشكالها بين الإضراب عن الطعام، والتظاهر، والاعتصام، والتوقّف عن العمل في مواقع المناجم. إضافةً إلى ذلك، قُطعت السكك الحديديّة لمنع نقل الفوسفات، وكذلك تصدّى النظام لهذه الحركة بوحشيّة، غير أنّها شكّلت منعطفاً مهمّاً بالنسبة إلى المجموعات السياسيّة المعارضة، وحرّرت الشبّان من الوهم، وحثّتهم على الفعل.
بالعودة إلى حالة مصر، يُلاحَظ أنّ تواتر الاحتجاجات العمّاليّة يشير إلى انخراطٍ جريءٍ بالنيابة عن المجموعات السياسيّة في تحدّي ثقافة الخوف والقصاص العنيف من جانب الحكومة. على مدار السنوات الخمس الممتدّة بين عامَي: 1988 و1993، شهدت البلاد احتجاجاتٍ عمّاليّةً يُقدَّر عددها بـ 162؛ أي: 27 احتجاجاً سنويّاً، غير أنّ المعدّل السنويّ ارتفع إلى 118 في السنوات الخمس الممتدّة بين عامَي: 1998 و2003. وتصاعد عدد الحراكات الجماعيّة إلى 256 عام 2004، معظمها ضمن قطاع تصنيع النسيج. وبحلول عام 2007، امتدّت الحراكات إلى قطاعاتٍ أُخرى من الإنتاج الصناعيّ، والخدمات العموميّة والمدنيّة، والمواصلات، والمهن الحرّة. وفي عام 2011، كان هنالك فقط ثلاثة اتّحادات عمّاليّة مستقلّة عن سيطرة الدولة المباشرة، نظّمت 1,400 توقّفٍ عن العمل واحتجاجٍ شارك فيها ما قُدِّر عدده بـ 600,000 عامل.
لا يزخر التاريخ القريب للمجتمعات العربيّة بانتفاضات الخبز والاحتجاجات العمّالية فحسب، بل أيضاً بالحركات الاجتماعيّة التي طالبت بتمثيلٍ سياسيٍّ واقتصاديٍّ منصفٍ للأقلّيات الإثنيّة والثقافيّة المهمّشة، وبالتعدديّة، والاعتراف بالاختلافات الثقافيّة، وتقويم عدم المساواة الجندريّة. عُرفت إحدى الحركات الاجتماعيّة البارزة باسم "الربيع الأمازيغي" في الجزائر (تافسوت إيمازيغن بالأمازيغية، أو القبائليّة، أو ببساطة: تافسوت؛ أي: "الربيع"). بعد إلغاء المحاضرة التي كان من المقرّر أن يُلقيها المفكّر الأمازيغيّ مولود معمري في مدينة تيزي وزو، أقيم إضرابٌ عامٌّ في 20 أبريل 1983 احتجاجاً على القرار الرقابيّ، واعتُقل مئات الناشطين والطلّاب الأمازيغ. كان هذا السخط تجاه عقدين من سياسة التعريب المتزمّتة التي طبّقتها أوتوقراطيّة جبهة التحرير الوطنيّ، والرفضِ المستمرّ من قبل الحزب الحاكم للاعتراف بالهويّة الأمازيغيّة عنصراً أساسيّاً في تكوين المجتمع الجزائريّ. وعلى الرغم من القمع الوحشيّ الذي قوبلت به هذه الحركة، فقد أثمرت إنشاءَ عدّة منظّماتٍ، مثل: التجمّع من أجل الثقافة والديمقراطيّة، والحركة الثقافيّة الأمازيغيّة. كما شكّل الربيع الأمازيغيّ حدثاً تأسيسيّاً بالنسبة إلى مجتمع حقوق الإنسان الوليد خارج الدوائر الأمازيغيّة؛ إذْ استندت انتفاضة الخبز التي اجتاحت البلاد في 1988 استناداً صريحاً إلى "الربيع الأمازيغيّ" في استراتيجيّات حشد الحراكات المدنيّة وتنظيمها.
أمّا "كفاية"، وهذا هو اللّقب غير الرسميّ للحركة المصريّة من أجل التغيير، فكانت ائتلافاً شعبيّاً لناشطين من مختلف القوى السياسيّة عبّر عن المعارضة العلنيّة لمساعي حسني مبارك إلى توريث ابنه جمال رئاسةَ الجمهوريّة المصريّة، وللفساد المستشري الذي ينهش الدولة، وللركود الاقتصاديّ، وثقافة الخوف، والاستخفاف التام بحقوق الإنسان. ظهرت "كفاية" للمرّة الأولى في صيف 2004، غير أنّ نشاطها ازداد وبدت أوضح للعيان بعد عام، ردّاً على استفتاءِ مبارك حول التعديلات الدستوريّة التي تمنحه فترةً رئاسيّةً إضافيّةً، وعلى حملتِه الانتخابيّة. وقد انبثقت "كفاية" من حركاتٍ اجتماعيّةٍ قامت قبل بضع سنواتٍ، وحشدت مجموعاتٍ مختلفةً من فئات الشعب، وعلى وجه التحديد: احتجاجات التضامن مع الفلسطينيّين خلال الانتفاضة الثانية (في 2000)، والاحتجاجات المناهضة للحرب التي تلت غزوَ العراق بقيادة الولايات المتّحدة في 2003. وقدحت هذه الأخيرةُ الزنادَ لقيام حراك 20 مارس المناهض للحرب، وكانت واحدةً من أكبر الحركات التي خرجت إلى الشوارع منذ تولّي مبارك زمام السُّلطة. كان أوّلُ تجمّعٍ دعت إليه "كفاية" في 12 ديسمبر 2005، وشكّل أوّل مناسبةٍ طالب فيها المواطنون المصريّون بتنحّي الرئيس. احتشد على عتبات مبنى دار القضاء العالي وسْط القاهرة عددٌ يتراوح بين 500 و1000 من الناشطين، الذين وقفوا بصمتٍ شبه تامٍّ، وقد أغلقوا أفواههم بالشريط اللاصق، حاملين لافتات عليها ملصق أصفر كبير كُتبت عليه كلمة "كفاية".
هذا تاريخٌ مسجَّلٌ، ومؤرشفٌ، وخاضعٌ للدراسة، لكنّه يمثل اطّلاعاً هامشيّاً على المنطقة العربيّة. كما أنّه أيضاً سُجِّلَ ونُقِل في الأغاني، والقصائد، والأدب، والأفلام، وهذه المجالات الإبداعيّة تكوّن مخزناً لذاكرة النضال، والمعارضة، والوقوف في وجه الاستبداد. وعلى عكس الأغاني، والقصائد، والروايات، يواجه انتقالُ الأفلام وعرضُها صعوبةً أكبر بكثير، نظراً إلى أنّ تداول الأفلام قبل انتشار الوسائط الرقميّة كان مقيّداً بالنواحي التقنيّة؛ وعليه، لم يكن الاطّلاع على هذا الإرث الغنيّ، المتمرّد، الآسر متاحاً لغير الباحثين، أو الهواة الشغوفين بالأفلام العربيّة مع الأسف.
كان من شأن انتشار الكاميرات الرقميّة خفيفة الوزن، وبرامج تحرير الفيديو أنْ يدمقرط إنتاجَ الأفلام إلى حدٍّ بعيد، في العالم العربيّ كما في بقيّة أنحاء العالم. ومع زيادة تطوّر كاميرات الهواتف الذكيّة تدريجيّاً، أخذت القبضة الرقابيّة تشتد حول عمليّة إنتاج الأفلام في المنطقة. وبالتزامن مع ذلك، كان السخط الاجتماعيّ والسياسيّ ينفجر بتواترٍ أكبر. منعت الأنظمةُ في أنحاء المنطقة العربيّة وسائلَ الإعلام (المسموعة-المرئيّة والمطبوعة) من تغطية الحركات الاجتماعيّة؛ على سبيل المثال: قبل 25 يناير 2011، كانت المنافذ الإعلاميّة في القاهرة –سواء في ذلك المحليّة، والإقليميّة، والدوليّة منها- ممنوعةً منعاً باتّاً من تغطية الاحتجاجات التي نظّمتها "كفاية"، أو تصويرها. لم تخرج في هذه الاحتجاجات أعدادٌ ضخمةٌ؛ إذْ لم يحشد واحدُها أكثر من خمسين إلى مئة ناشطٍ، سُمح لهم بالمسير مسافات قصيرة، أو الوقوف أمام المبنى الذي يضمّ نقابة المحامين، أو المبنى المجاور الذي يضمّ نقابة الصحفيّين، وكذلك تجمّعوا في مناطق ذات رمزيّة معيّنة، مثل: ميدان طلعت حرب. وعادةً ما جرى التصدّي لهذه المجموعة الصغيرة من قِبل عناصر أمنٍ وطنيٍّ مجهَّزين بمعدّاتِ مكافحة الشغب، يفوقونها عدداً بضعفين، أو ثلاثة، ولم يكن ينتبه إلى المحتجّين سوى سكّان المنطقة، أو من يمرّون مصادفة. حتّى التقارير الإذاعيّة المختصّة بالسير والطرقات لم يُسمح لها أن تذكر الاحتجاجات، على الرغم من أنّ تجمُّع شرطة مكافحة الشغب كان يعطّل حركة المرور تعطيلاً كبيراً. من المرجّح أنّ أرشيف الأمن الوطنيّ الذي يرجع إلى عهد مبارك يحتوي على أكبر السجلّات وأكثرها شمولاً لهذه الاحتجاجات، غير أنّها بالنسبة إلى عموم المصريّين، ستظلّ مسجّلةً إلى الأبد ضمن فيلمين روائيّين اثنين: فيلم عين شمس لإبراهيم البطوط (2008) وفيلم جنينة الأسماك ليسري نصر الله (2008)، وهما فيلمان مختلفان للغاية، أُطلِقا في العام نفسه، يسلّطان الضوء على الحياة اليوميّة الشاقّة اليائسة، ويصوّران الاحتجاجات في منطقة وسط البلد.
كان إبراهيم البطّوط مصوّراً صحفيّاً، وتلفزيونيّاً شهيراً، غطّى العديد من الحروب في يوغوسلافيا السابقة والسودان، إضافةً إلى حرب الخليج الأولى. لم يُتمّ مهامَّه بدون أن يمسّه الأذى، وعقبَ عودته إلى القاهرة، بدأ العمل مصوِّراً سينمائيّاً مع صُنّاع أفلام مستقلّين، وأخرج عدّة أفلامٍ وثائقيّة. وقد ضمّ فيلمُه الروائيّ الثاني، عين شمس، قصصاً من تجاربه الخاصّة: هموماً شهدها ووثّقها، وأُخرى ربطَ بعضَها ببعض متعمّداً؛ العواقب الوبيلة لليورانيوم المُنضَّب الذي خلّفَته القواتُ الأمريكيّة في حرب الخليج الأولى، الأوضاع المعيشيّة المتردّية للفقراء العاملين في القاهرة، انعدام الوصول إلى تطبيبٍ لمرض السرطان لدى ابنة سائقِ سيّارة أجرة في الحادية عشرة من عمرها، الخسائر الفادحة التي نتجت عن انتشار وباء إنفلونزا الطيور. بميزانيّة إنتاجٍ شحيحةٍ، صوّرَ البطّوط الفيلم بتقنيّة الفيديو الرقميّ بدون أذوناتٍ رسميّةٍ، فمزج الوثائقيّ بالروائيّ، ودعا الممثّلين إلى الارتجال متفاعلين مع موجودات محيطهم، مستعيناً بطاقمٍ مستعدٍّ للمجازفة بمواجهة القصاص. منعت الرقابةُ عرضَ الفيلم في مصر وبقيّة العالم، مع تهديدٍ بالعقاب للمخرج والطاقم. وعرضَ المركز السينمائيّ المغربيّ (تحت إدارة الراحل نور الدين الصايل) أن يُجيز الفيلم، فيعلنه إنتاجاً مغربيّاً، ويتيح صنعَ أشرطة الـ 34 مم التي مكّنت الفيلم من أن يشارك في المهرجانات، ثمّ يُعرَض في مصر نهايةَ المطاف، بعد رفع المنع الرقابي له. في أحد المشاهد المحوريّة، يوصل أحدُ شخصيّات الفيلم –وهو سائق سيّارة أجرة يُدعى رمضان (محمد عبد الفتاح)- راكباً إلى وسط البلد، فيصادفان مظاهرة؛ وإذْ يحاول السائقُ التملّصَ من الازدحام المروريّ الناتج، يشاهد رجالَ الشرطة يضربون أحد المتظاهرين الذي يتمكّن من الفرار ويحتاج إلى تلقّي الرعاية الطبيّة الفوريّة. يُدخله رمضان إلى سيّارته مصدوماً، ويُنقذه متغلّباً على خوفه من العقاب العنيف. صوّر البطّوط المشهد عن طريق إحضار ممثّليه ومعدّاته إلى قلب مظاهرةٍ حقيقيّةٍ مندلعةٍ؛ إذْ استطاع أن يضع مخطّطاً بالحدّ الأدنى ليستثمر الفرصة، مدركاً مدى تكرار هذه المظاهرات.
أمّا فيلم جنينة الأسماك ليسري نصر الله فله قصّة مختلفة تماماً؛ إذْ كان إنتاجاً دوليّاً مشتركاً بين مصر (أفلام مصر العالميّة)، وفرنسا (Archipel 33)، وألمانيا (Pandora Films)، بتمويلٍ من Arte France وصندوق السينما العالميّة. يضمّ طاقم عمل الفيلم كلّاً من النجوم المصريّين: عمرو واكد، وجميل راتب، وباسم سمرة، وأحمد الفيشاوي، وهند صبري تونسيّة الميلاد. تروي حبكةُ الفيلم قصّةَ مصادفةٍ تجمع بين شخصيّتين فاترتين هما: ليلى (هند صبري)، مذيعة راديو تقدّم برنامجاً ليليّاً تستمع فيه إلى مشكلات الناس الذين يتصلون بها طالبين نصحها؛ ويوسف (عمرو واكد)، طبيب تخديرٍ، وحيدٌ، متبلّد العواطف، يتصالح مع موت والده البطيء الوشيك من المرض. وفي سياق التمهيد للقائهما، تتحدّث الشخصيّاتُ الثانوية –التي تتقاطع خيوط حياتها مع خيوط حياتهما- إلى الكاميرا مباشرةً، بأسلوبٍ يكاد يكون اعترافيّاً. ثيمة الفيلم الرئيسة هي الشقاء المتجذّر لدى القاهريّين، والمشهد الافتتاحي مذهلٌ على نحوٍ خاصّ؛ إذْ تحوم الكاميرا فوق المنظر الليليّ لوسط البلد، ويقول رجُلٌ بتعليقٍ صوتيّ: «خايف»، ثمّ يأخذ في مونولوجٍ طويلٍ، بتعداد ما يخيفه. يتضمّن الفيلم مشاهدَ تُظهر مزارعَ دواجن في إشارةٍ مباشرةٍ إلى إنفلونزا الطيور، إضافةً إلى مشاهد للمظاهرات المتكرّرة وسط البلد.
حين بدأ الإضراب في مناجم فوسفات قفصة عام 2008 بتونس، فرضت الحكومة تعتيماً إعلاميّاً صارماً للغاية. وفي نهاية المطاف، قُطعت خدمات الإنترنت مؤقّتاً لمنع الناشطين من إرسال التقارير إلى التونسيّين وبقيّة العالم. ظهرت صورُ الأحداث التي التقطها الناشطون المضربون بعد بضعة أيّام؛ إذْ بدأوا يستخدمون شبكاتٍ سريّةً غير قابلةٍ للتعقّب أقامها قراصنة إنترنت دوليّون. وعلى نحوٍ مماثلٍ، جرى "تهريب" مقاطع الفيديو التي التقطها العمّال المضربون في شركة مصر للغزل والنسيج عبر شبكاتٍ أقامها الناشطون في تحدٍّ للتعتيم الإعلاميّ التام الذي فرضته قوّات أمن مبارك بصرامة. كشفت بعض المقاطع عن حنكةٍ سياسيّةٍ لدى العمّال المضربين لم تكن متخيَّلةً في السابق؛ إذْ وثّقت مقاطعُ –على سبيل المثال- احتلالَ العمّال لمساحة معملٍ معظم العاملين فيه من النساء اللاتي رفضن أنظمة الإدارة الجديدة. ربطت هؤلاء العاملات أنفسهنّ بالآلات، في حين كان أزواجهنّ يحضرون لهنّ الوجبات برفقة أبنائهنّ في زيارةٍ لأمّهاتهم المحتجزات في الموقع طوعاً.
لقراءة النص كاملاً يرجى تحميل الملف المرفق أدناه.













/thumb_150x120_2_michele_trimarchi_new_(1).png)